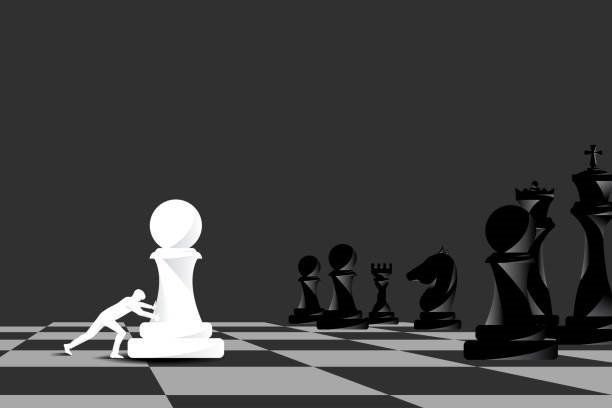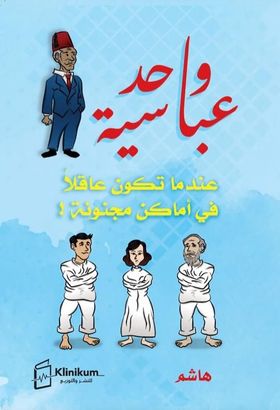بواسطة 288e1451-5677-4d83-8385-71f24185e9e0
•
١٢ يوليو ٢٠٢٤
ماذا لو اختفيت اليوم من الحياة... هل سيتأثر المحيطون بك؟ هل سينقص الحياة شيء؟ بعد يومٍ مرهق من العمل كانت جالساً في غرفتي شارد الذهن، فسمعت صوت أمي تسأل من في المنزل عني "هل ما زال هاشم موجود أم خرج؟"، فتسللت إلى ذهني حينها مقولة الفيلسوف رينيه ديكارت "أنا أفكر إذاً أنا موجود"، لذا أردت الخروج من غرفتي لأخبر أمي ممازحاً أنني كنت هنا أفكر فإذاً أنا موجود. لكن أمي شتت أفكاري ودمرت ما تبقى سليماً من عصبونات دماغي ولم تذر لي أي باقية من صلابتي النفسية، إذ سمعتها تقول لمن سألتهم "هاشم موجود فهذا نعاله عند باب الغرفة.... هاشم تعال وارمي أكياس الزبالة". آه يا سيدي القارئ... لا أخفيك السر... لقد كانت صعقة نفسية، إذ كان دليل وجودي نعال.... وحاجتها مني أكياس القمامة لا أكثر. لست مفكراً... ولكن السؤال الذي سهر معي تلك الليلة هو " إلى أي مدى أنا مهم ومطلوب ومُلاحظ ومؤثر في هذه الحياة؟!" وأظنه سؤال يراود الكثير من الناس أحياناً، وليس سؤالاً فلسفياً أو ترفاً فكرياً، بل إن لجوابه أثر نفسي ينعكس علينا وعلى صحتنا ومشاعرنا... وهذا ما أود الحديث عنه في كلماتي اليسيرة هذه. نحن كبشر لن نقول لمن سألنا "كيف حالك؟" - أشعر اليوم بالأهمية شكراً لك.، ولكن هذا الشعور قد يجعلك تشعر بخير فعلاً. الاحساس بهذا الشعور لا يتطلب نيل جائزة نوبل للسلام، بل يكفي أن تكون مؤثراً بحياة الناس من حولك أو بمحيطك الذي تعيش فيه، وكلما كنت مطلوباً وملاحظاً ومؤثراً أكثر كلما زاد اعتقادك بأهمية وجودك. وعندما تكون بمنظورك ذا أثر وأهمية سترى ذاتك بنوع من التقدير والاحترام، مما ينعكس على شعورك بالإيجاب، وهذه النظرة للذات لا تـتعلق بالغرور وتفضيل النفس على الآخرين، بل تعني استثمار نقاط قوتك وأحاسيسك لأجل الحياة ومن فيها. إن حب ترك بصمة على الحياة فطرة نولد عليها وتخالج أنفسنا إلى حين الممات، وهذا ما أكده أستاذ الفلسفة وعلم النفس كارل جروس Karl Gross عندما كتب نظرية قَـيّـمة حول لعب الأطفال، قال فيها: إن الأطفال الصغار يشعرون بسعادة كبيرة عندما يعتقدون أنهم مؤثرين في العالم من حولهم، فالطفل مثلاً عندما يمسك دمية ويضغطها لتخرج صوتاً يضحك كثيراً، ليس لأن الصوت مضحك بل لأنه شعر بتأثيره في الواقع، ويكرر العملية ليعيد نشوة متعة الإنجاز وأهمية وجوده، والطفل الذي يُحرم من اللعب أو يلعب مراراً ويفشل بالتأثير على الواقع يشعر بانزعاج الكبير، بل لربما يتقوقع على نفسه ويتشوه نفسياً فيكون ضعيف الشخصية مستقبلاً غير مهيأ للإنجاز. وهناك بحث أجراه الدكتور إلين لانجر من جامعة هارفارد على مجموعتين من كبار السن نزلاء دار رعاية المسنين، أعطوهم جميعاً بعض النباتات التي ستزين غرف جلوسهم ونومهم وممرات الدار، وأخبر الدكتور إلين المجموعة الأولى أنهم المسؤولون عن إبقاء النباتات على قيد الحياة والعناية بها ورعايتها لتضفي المزيد من الجمال والمنظر الصحي للدار، بينما أخبر المجموعة الثانية أن النباتات لهم ولكن موظفو الدار هم من سيعتنون بها. بعد 18 شهر من الاهتمام بالنباتات والتأثير بالمنظر الصحي لدار الرعاية كان ضعف عدد نزلاء المجموعة الأولى على قيد الحياة مقارنة بالمجموعة الثانية. أي أن الشعور بالتأثير على الحياة وما يحيط بنا يجعلنا أفضل سواء على الناحية الصحية أو الشعورية أو حتى على بناء الشخصية. وفي بحث رائع نُشر أمس -وهو ما دفعني لكتابة هذا المقال- وجد الباحثان في مجال علم الأعصاب المعرفي روبرت تشافيز وتود هيثرتون أن التقييم الإيجابي لأهمية الذات واحترام الذات يكمنان في ذات المنطقة في الدماغ، فكلاهما في المسار الجبهي للدماغ والذي يربط قشرة الفص الجبهي الإنسي بالمخطط البطني، أي هما وجهان لعملة واحدة، وكلما كان تقدير الذات أفضل كلما تحسن أداء هذا المسار عصبياً، والمهم هنا أن قوة هذا المسار تُحسن مستويات السيروتونين "هرمون السعادة"، والذي هو حتماً يؤثر على المزاج العام ويقلل القلق، بل ويمنع خطر الإصابة بعدة أنواع من الاضطرابات العاطفية والنفسية كالاكتئاب وانعدام الشهية أو فرط تناول الطعام. وكتبا في البحث أن الأشخاص الذي يكون لديهم هدف نبيل يتعلق بالتأثير في الحياة والناس من حولهم يرتفع لديهم الدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين وهي ناقلات عصبية تتحكم في الحالة المزاجية والحركة والتحفيز والتي يسمونها عادة "ثلاثية السعادة"، أي كلما كنت نبيلاً في تأثيرك فيمن حولك زادت سعادتك وتقديرك للذات. للتبسيط... ولكي أخرجك من دهاليز الدماغ هذه أقول إن احترام الذات من خلال الشعور بأهميتها يمنحها صلابة نفسية وثقة في النفس وسعادة تقيك من التكدر العاطفي والنفسي. وختاماً... هناك لَبسٌ يجب التنويه عليه، يخلط الكثير من الناس بين احترام الذات وتقديرها وأشياء أخرى لا علاقة لها بالاحترام أساساً، فمثلاً يظن البعض أن الاحترام والتقدير للذات يعني أن الإنسان يجب أن يوفر لنفسه كل متع الحياة طولاً وعرضاً، فيأكل كل ما تشتهيه نفسه ويشتري ما يحب كتقدير للنفس، وهذا خطأ، بل إن من الحيوانية أن يجعل الإنسان نفسه مسخاً يطلق العنان لرغباته، فوحدها الحيوانات التي لا تراعي سوى شهواتها وما تستلذ به، بينما الإنسان من المفترض أن يكون لديه قيم ومبادئ وتضحيات، وإلا فما فرقه عن الحيوان؟!! وكما ذكرت سابقاً ليس هناك أي ربط من قريب ولا بعيد بين الغرور وبين تقدير الذات، فالأفضلية تعني المزيد من المسؤولية اتجاه الحياة ومن فيها، بينما النظرة الفوقية على الآخرين مجرد نرجسية مرضية لا أكثر. لذا تبقى القاعدة الذهبية في أفضلية الذات والشعور بأهميتها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيه: "خير الناس أنفعهم للناس". أنت خير الناس ما دمت مؤثراً وهماً في منفعة الناس، وأنت مجرد مسخ لا أهمية لوجودك ما دمت منغمساً في ملذاتك.